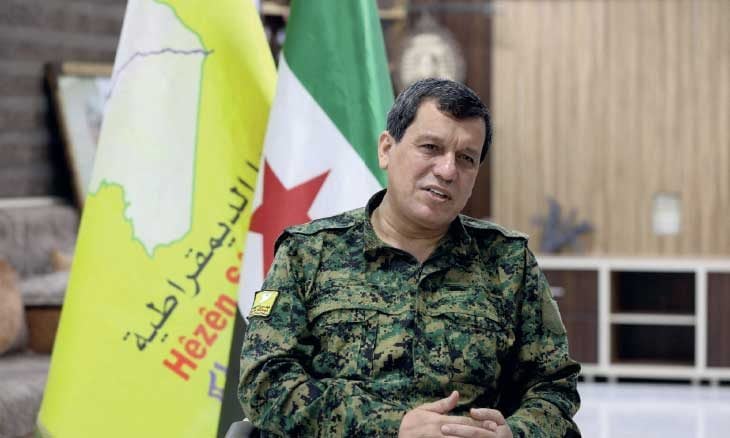عبد الناصر العايد
ليس من المستطاع التفكير في قوات سوريا الديموقراطية، وجانبها المدني المسمى بالإدارة الذاتية، سوى بأنها مشروع مؤقت يرتبط بقاؤه من عدمه بوجود العلم الأميركي في شرق الفرات. فهذه القوات عجزت عن صناعة عقد اجتماعي أو إيجاد أي شكل مؤسساتي يمنحها، ولو جزءاً يسيراً من الشرعية، ويعينها على صناعة التوافقات وإدارة النزاعات في الرقعة الجغرافية والاجتماعية التي تهيمن عليها، وهو ما تجلى بوضح في الصراع الذي تفجر في دير الزور مؤخراً.
ففي مواجهة اضطراب مجتمعي واسع، لم تجد “قسد” سوى البندقية وسيلة لحل المعضلة، وتوارت واختفت على الفور مئات المؤسسات الصورية التي اصطنعتها، ولم تسجل حضوراً يذكر في جهود حلّ النزاع. وما هو أوضح، أن القوات وقيادتها لم تفكر حتى في الاستنجاد بتلك الهيئات والمنظمات التي زعمت يوماً أنها نابعة من المجتمع وتمثله. ويعيدنا ذلك إلى المثل الإنكليزي الشهير الذي يقول بأن الحَدّاد لا يمتلك سوى أداة واحدة لحل مشاكله، هي المطرقة. وحتى في الحالة هذه، فإن مطرقة “قسد”، أي السلاح، مستعارة من لدن واشنطن، ولن يكون في إمكانها استخدامها دائماً وابداً.
يظهر بؤس مشروع قوات سوريا الديموقراطية، وفقره أيضاً، في الجانب العربي المعارض له. فمن ثاروا ضدها هم قبائل وعشائر، أي بُنية بدائية موروثة، ولو أنها صحيحة مزاعم “قسد” وقادتها بأنهم يحكمون المنطقة على نحو حداثي وديموقراطي، لرأينا أن شكل مناهضتها يتخذ على الأقل طابعاً مؤسساتياً حديثاً في بعض جوانبه. لكن هذا الشكل من المحال أن يظهر فيما لا تعترف تلك القوات سوى بالعشائر وشيوخها كقوى فاعلة، وتمنع وتقمع أي نشاط ذي صبغة مدنية حديثة، وتعتقل وتسجن القائمين عليه.
يستنكر داعمو “قسد”، شكل الاحتجاج العرقي الذي ظهر بتعبيرات قومية عربية متشنجة، متناسين أن تلك السلطة هي التي فرضت على أبناء المنطقة الصيغة العشائرية كصيغة وحيدة مقبولة للتمثيل الاجتماعي/السياسي. فسكان شرق الفرات يجب أن يظهروا على الدوام على أنهم مجرد “عربان” وعشائر، لا كقوة أو قوى سياسية يحق لها المطالبة والمنافسة على الحكم، وهذه السياسة “العشائرية” كما يعرف الجميع، لا يمكن أن تؤول في نهاية الأمر سوى إلى الاتحاد في تعبيرات قومية متطرفة وجامحة.
إن الأكراد، كما نعرفهم في سوريا على الأقل، ما هم إلا عشائر وقبائل، ولا قائد أو عنصر في “قسد” إلا وله نسبة ما إلى واحدة من تلك القبائل، على شاكلة نظرائهم العرب. لكن الكرد تجاوزوا ذلك الشكل البدائي بفضل تجاربهم ونضالهم الباكر من أجل إيجاد دولة لهم، وكان الدرس الأول الذي أتقنوه هو أن البنى البدائية التقليدية لا يمكن أن تبلغ بهم حلم الدولة، فتجاوزوها إلى أشكال تنظيم أكثر حداثة وفعالية، هي الأحزاب والمنظمات السياسية المبنية على أسس عقلانية.
لكن حزب العمال الكردستاني الذي يشرف فعلياً على إدارة منطقة شمال شرقي سوريا، قرر استثمار الدرس في اتجاه آخر، وهو حرمان منافسيه وخصومه من أي نوع من التنظيم الفعال، وحشرهم في المضمون الذي لا يوحد، ولا يولد أي قوة حقيقية، أي الصيغة العشائرية التي امتثلت لها المجتمعات العربية وانصاعت لها بكامل عقلها.
ولأن للتاريخ مَكرَه، فإن تلك السياسة انقلبت على صانعها. فالخاصرة الرخوة هذه سيسهل على أي قوة منافسة اختراقها واستثمارها، بسبب ضعفها الشديد وعدم قدرتها على وعي المشهد أو التعامل مع عناصره المتحركة. وقد وقعت العشائر العربية فريسة لدعاية وخديعة واحد من ألدّ أعدائها وخصومها، وهو الجانب الإيراني بالتعاون مع النظام السوري التابع له، وكان ذلك الاستخدام سينجح لولا ارتكاب أخطاء كبيرة من قبل المنفّذين، ووعي بعض النخب في شرق الفرات، وليس بفضل بندقية “قسد” كما يظن مناصروها.
ليست لديّ نصائح لقوات سوريا الديموقراطية، فقد راقبتُ مسلكها من كثب لسنوات طويلة، وترسّخت لدي قناعة بأنها كيان قومي متطرف، مهما حاولت برقعة وجهها. وهذا سيستفز ويستنفر عداءً قومياً مضاداً بالضرورة، وبالضرورة أيضاً ستخسره لأنها، وفق هذا التصنيف، أقلية وضعيفة على نحو فاقع، وقرارها النهائي يملكه حزب متكلس لن يسمح لها بإصلاح نفسها. وهي مثل حدّاد الإنكليز ومثل نظام الأسد، لا تملك سوى مطرقة الحل الأمني والعسكري لحل مشاكلها، ولا يمكننا أن نتمنى أو نتخيل مثلاً أن تُجري “انتخابات” في مناطق سيطرتها، باعتبار ذلك أبسط وأسهل تعبير عن الديموقراطية المزعومة، بما يؤسس لعقد اجتماعي حقيقي يتم من خلاله تقاسم وتشارُك السلطة التي يستأثر بها الكرد اليوم، وسيستأثرون بها غداً، بشكل مطلق.
لكن لديّ نصيحة للسكان العرب في تلك الأصقاع ونخبهم، وهي أن يتعلموا من جيرانهم الكرد، وأن يتوجهوا إلى الأشكال والأدوات الأكثر حداثة وفعالية لممارسة السياسية، وخلع ثوب العشائرية البالي الذي يكتنف كل مرضٍ وبيل. فما تحتاجه مناطقهم ليس إعلاء الرايات القبَلية وإحياء النخوات، بل التطلع إلى ما يربطهم بالمستقبل، أي التنمية من كافة جوانبها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقبل ذلك كله، تنمية الوعي وتنظيم الممارسة السياسية، فلا نشاط بشرياً في عصرنا الراهن يمكن أن يولد ويحيا إلا تحت مظلة السياسة المنظّمة والعقلانية.
المصدر: المدن